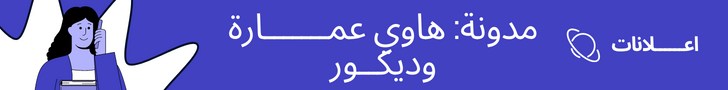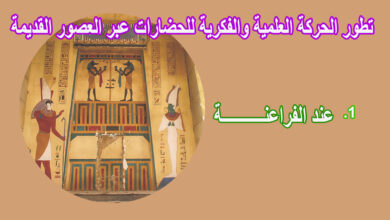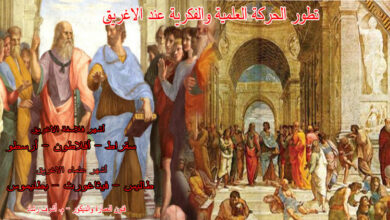رحلة الغزالي من الشك إلى اليقين
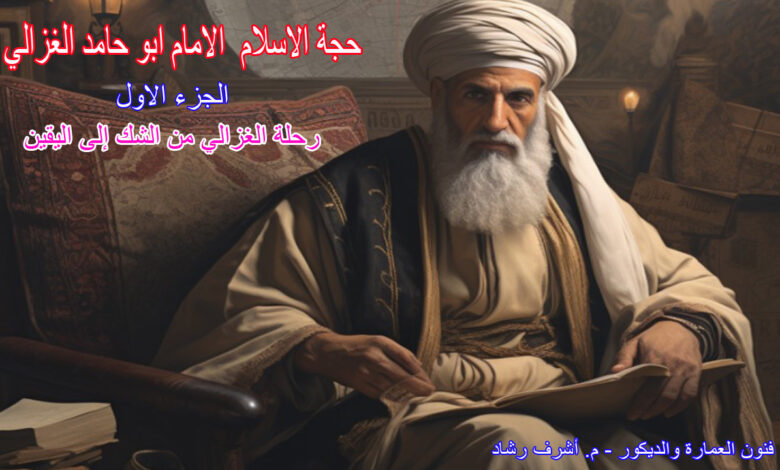
رحلة الغزالي من الشك إلى اليقين: من طفولة الفقر إلى أستاذية الدنيا في عصره، حينما نقرأ في سير العظماء، نجد أن الظروف القاسية قد تصنع عقولًا جبارة. ومن أبرز هؤلاء الإمام أبو حامد الغزالي، الذي وُلد فقيرًا بلا جاه، ثم صار أحد أعظم علماء المسلمين في التاريخ، وقد ترك أثرًا بالغًا في الفقه، والفلسفة، والتصوف، وعلم الكلام، والمنطق، والأخلاق الإسلامية. حتى لقّبه التاريخ بـ”حجة الإسلام”. لكن هذه المكانة لم تأتِ بسهولة، فقد كانت حياته سلسلة من التحديات الفكرية والروحية انتهت برحلة بحث عميقة عن الحقيقة. في هذا المقال نعرض قصة الغزالي من مولده حتى لحظة أزمة الشك التي قلبت حياته رأسًا على عقب.

نشأته وبداياته العلمية:
الميلاد والنشأة: حلم أب فقير في صناعة عالم كبير
وُلد الإمام أبو حامد محمد الغزالي عام 450 هـ/1058م في بلدة طوس بخراسان [1] “تقع في شرق إيران حالياً”، في أسرة بسيطة الحال. كان والده متواضع الحال، يعمل في غزل الصوف وبيعه لتأمين لقمة العيش لأسرته الصغيرة، وكان لديه طفلان: الغزالي وشقيقه أحمد.
منذ صغره، تربّى الغزالي على الانصات لمجالس الفقهاء، حيث كان والده يرافقهم ويخدمهم، متمنياً أن يكون أبناؤه فقهاءً. وعندما اقترب أجله، كلّف صديقًا صوفيًا بتعليم الغزالي وشقيقه، قائلاً:
«إِن لي لتأسفاً عظيماً على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فاتني في وَلَديّ هذَيْن فعلّمهما ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلّفه لهما».
فلما مات أقبل الصوفيّ على تعليمهما حتى نفد ما خلّفهما لهما أبوهما من الأموال، فنصحهما باللجوء إلى مدرسة ويكونا من طلبة الْعلم فَيحصل لَهما مسكن وقوت يعينهم حياتهم»، ففعلا ذلك وكان هو السبب في علو درجتهما، وكان الغزاليّ يَحكي هذا ويقُول: «طلبنا الْعلم لغير الله فأبى أن يكون إِلّا لله». وقد كان هذا القرار سببًا رئيسيًا في صعود الغزالي لاحقًا إلى القمة العلمية.
رحلته في طلب العلم حتى صار إمامًا:
تلقى الغزالي تعليمه المبكر في مسقط رأسه، حيث درس الفقه في طوس على يد الشيخ أحمد الراذكاني، ثم رحل إلى جرجان وطلب العلم على يد الشيخ إسماعيل بن سعدة الإسماعيلي،
وفي طريق عودته من جرجان إلى طوس، واجهه قطّاع طرق، وأخذوا جميع ما معه ومضوا فتبعهم فالتفت إليه مقدّمهم وقال: ارجع ويحك وإِلا هلكت! فقال له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتي فقط فما هي بشيء تنتفعون به. فقال لي: وما هي تعليقتك: فقلت: كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك وقال: كيف تدّعي أنّك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلّم إِليه المخلاة». بعد ذلك قرّر الغزالي الاشتغال بهذه التعليقة، وعكف عليها 3 سنوات من 470 هـ إلى 473 هـ حتى حفظها، ومن يومها والغزالي لم يعد يترك كتاب الا حفظة واختزله في عقلة.
ثم رحل الغزّالي إلى نيسابور ولازم إِمام الحرمين أبو المعالي الجويني (إمام الشافعية في وقته، ورئيس المدرسة النظامية) فدرس عليه مختلف العلوم، من أصول الفقه، وعلم الكلام، والمنطق، والفلسفة، وجدّ واجتهد حتى برع وأحكم كل تلك العلوم، ووصفه شيخه الجويني بأنه: «بحر مغدِق». وكان الجويني يُظهر اعتزازه بالغزالي، حتى جعله مساعداً له في التدريس، وعندما ألف الغزالي كتابه “المنخول في علم الأصول” قال له الجويني: «دفنتني وأنا حيّ، هلّا صبرتَ حتى أموت؟».
بعد وفاة الجويني، قصد الغزالي بغداد، عاصمة الخلافة العباسية، وهناك لمع نجمه حتى ولاه الوزير نظام الملك التدريس في المدرسة النظامية، أكبر مدرسة في العالم الإسلامي آنذاك.
مكانته في نيسابور وبغداد وأستاذية الدنيا
وفي بغداد، صار الغزالي أستاذ الدنيا، يقصده العلماء والطلاب من الآفاق، يدرّس الفقه والأصول والمنطق، ويناظر الفرق والمذاهب. ازدادت شهرته حتى غلبت على معاصريه، وأقبل الناس عليه، لكنه في خضم هذا المجد، بدأ يشعر باضطراب في قلبه، وتساؤلات تهز يقينه: هل ما أدرّسه هو الحقيقة؟ أم مجرد كلام يجادل به الخصوم؟
الانعطاف الحاسم في حياة الغزالي: بين شهوات الدنيا ونداء الآخرة
لاحظ الغزالي نفسه منغمسًا في العلاقات الاجتماعية والاهتمام بالعلم والمكانة، لكنه أدرك أن غالب علمه وتدريسه غير نافع في سبيل الله، وأن نيته توجهت إلى طلب الجاه والشهرة، لا رضى الله تعالى. شعر حينها أنه على شفا جرف هار، وأن استمرار حياته على هذا النهج قد يقوده إلى الهلاك الأبدي.
ظل يفكر في هذا الأمر لمدة طويلة، متأرجحًا بين رغبات الدنيا ونداء الآخرة. كانت شهواته تجذبه إلى الحياة الدنيوية، بينما كان الإيمان يناديه: “الرحيل، الرحيل!”، مؤكدًا له أن عمره قصير، وأن عليه الاستعداد للآخرة قبل فوات الأوان.
بعد صراع داخلي دام نحو ستة أشهر، بدأ الغزالي يشعر بالاضطرار الحقيقي، إذ أغلق الله على لسانه ومنعه من التدريس، ما أجبره على مواجهة نفسه عاجزًا عن مواصلة التدريس والظهور بين الناس. هنا لجأ إلى الله تعالى بقلوب منكسرة، متضرعًا ومجاهدًا، فاستجاب له المولى، وسهّل عليه ترك الجاه والمال والأولاد والأصحاب، وأصبح قلبه صافيًا مهيأ للعبادة.
وفي ذو القعدة سنة 488 هـ غادر الغزالي بغداد، وتوجه للحج ثم إلى الشام وفلسطين، حيث قضى حوالي عشر سنوات في الخلوة والزهد والتأمل. عاش الغزالي في عزلة، مكرسًا وقته لرياضة النفس، وتزكية القلب، وذكر الله تعالى، حتى صار معتادًا على الاعتكاف في منارة مسجد دمشق طول النهار، بعيدًا عن صخب الدنيا وضجيجها.
مرحلة الشك الفكري وبداية البحث عن الحقيقة:
في رحلة الغزالي من الشك إلى اليقين نجد أنه شيئًا فشيئًا، استبدّ به القلق، فلم يجد الطمأنينة في الجدل العقلي ولا في المناظرات. وأصيب بمرض أقعده، حتى عجز عن الكلام أمام تلاميذه، وفقد شهيته للطعام، وبعدما إرتحل إلى الشام وفي خلوته أخذ يسأل نفسه: ما الطريق إلى اليقين؟ وما معيار الحقيقة؟ فتأمل في وسائل المعرفة التي يعتمد عليها الناس: التقليد، الحواس، والعقل.
- التقليـــــــــــــد:
- رفض الغزالي أن تكون الحقيقة مبنية على مجرد التقليد؛ لأنه يرى أن من يقلد دين أبويه لكونه نشأ عليه ليس على يقين، إذ لو نشأ على دين آخر لقلده.
- الحـــــــــواس:
- وفي رحلة الغزالي للوصول لحقيقة المعرفة يقول: فبدأت أولاً في إختبار الحواس التي نرى ونسمع ونلمس ونشم ونتذوق بها، ووجدت أن كل هذه الحواس تخطئ، كالذي يرى الظل ساكنًا وهو يتحرك، أو يرى الكوكب صغيرًا وهو في الحقيقة أكبر من الأرض. ولذلك لا يعتمد عليه في الوصول للحقيقة.
- العقـــــــــــــــل:
- لجأ بعد ذلك إلى العقل، لكن وقع له ما وقع مع الحواس؛ إذ تساءل: من أين الثقة بالمحسوسات، وأقواها حاسة البصر، وهي: تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة، بعد ساعة، تعرف أنه متحرك.
- ثم تنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار، فقال: قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات، كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون موجودًا ومعدوماً في أن واحد، فائن الحقيقـــــــــــة؟.
- فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقاً بي، فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر، إذا تجلى، كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه، وعدم تجلي ذلك الإدراك، لا يدل على استحالته.
فظهر له: أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك؛ بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة، لو تحدى بإظهار بطلانه مثلًا من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً، لم يورث ذلك شكًّا وإنكارًا؛
فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، فلو قال لي قائل: لا، بل الثلاثة أكثر من العشرة، بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً ، وقلبها، وشاهدت ذلك منه، لم أشك بسببه في معرفتي، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه! فأما الشك فيما علمته، فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه، ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين، فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه، فليس بعلم يقيني.
توقفت النفس في جواب ذلك قليلاً، وأيدت إشكالها بالمنام، وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أموراً، وتتخيل أحوالاً، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً، ولا تشك في تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل.
فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل، هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها؟ألا يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك، كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون يقظتك نوماً بالإضافة إليها! فإذا وردت تلك الحالة، تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها، ولعل تلك الحالة هي الموت.
يقول علي بن أبي طالب، وقيل: من كلام سهل بن عبد الله التستري: (الناسُ نيامٌ، فإذا ماتوا انتبـهوا). فلعل الحياة الدنيا نوم بالنسبة إلى الآخرة؛ فإذا مات العبد ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهدها الآن، ويقال له عند ذلك: {فكشفنا عنكَ غطاءكَ فبصرُكَ اليومَ حديدٌ}.[2]
النور الإلهي: لحظة التحول من الشك إلى اليقين
يقول الغزالي في كتابه “المنقذ من الضلال”: فأعضل علي هذا الداء، ودام قريباً من شهرين، حتى شفاني الله تعالى من ذلك المرض، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بـها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، ولما سئل رسول الله عن الشرح في قوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام}.[3]
ومن هنا فهم الغزالي أن اليقين ليس ثمرة الجدل العقلي وحده، بل هو هبة إلهية، ونور يقذفه الله في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو نور يقذفه الله تعالى في القلب. فقيل: وما علامته؟ قال: “التجافي عن دار الغُــــــــــــرُورِ، والإنابة إلى دارِ الخُلُـــــــــــــود“.
هكذا وصل الغزالي في رحلته العقلية إلى مرحلة حرجة من الشك، لم يترك فيها وسيلة من وسائل المعرفة إلا وفحصها ونقضها، حتى الحواس والعقل اللذان يعدّان أساس اليقين عند معظم الناس، لم يسلما من نقده العميق. لقد عاش تجربة الشك بكل تفاصيلها، تجربة زلزلت كيانه المعرفي، وأدخلته في أزمة وجودية كادت تودي به إلى هاوية اليأس لولا أن قذَف الله في قلبه نورًا أعاد له السكينة واليقين.
كان هذا النور الإلهي نقطة التحول التي نقلته من ظلمات الحيرة إلى إشراقة الإيمان، وأدرك أن الحق لا يُنال بمجرد الجدل العقلي، بل بصفاء القلب وتطهير النفس.
قصة كتاب إحياء علوم الدين
كتاب إحياء علوم الدين يعد أعظم مؤلفات الغزالي وأشهرها على الإطلاق. قصته مرتبطة برحلته الروحية:
- بعد أن عاش الغزالي مرحلة الشك العميق، وأيقن أن عليه أن يفرّ بنفسه إلى الله. فترك التدريس في المدرسة النظامية ببغداد عام 488هـ، وانعزل عن الدنيا، متنقلاً بين الشام (دمشق)، والحجاز، والقدس، لمدة قاربت عشر سنوات.
- في هذه الفترة، عاش حياة الزهد والخلوة، مقبلًا على العبادة والتأمل، متأثرًا بالطريق الصوفي العملي الذي يربط بين العلم والعمل، والعقل والقلب.
- خلال هذه الخلوة، بدأ في تأليف كتابه العظيم إحياء علوم الدين، الذي استغرق سنوات في كتابته، حتى خرج في أربعة مجلدات ضخمة، تُقسم إلى أربعة أرباع:
- ربع العبادات: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج.
- ربع العادات: الزواج، الكسب، الأكل، اللباس.
- ربع المهلكات: الأمراض القلبية مثل الكبر، الحسد، الرياء.
- ربع المنجيات: التوبة، الصبر، الشكر، الخوف، الرجاء.
الكتاب لم يكن مجرد موسوعة فقهية أو نظرية، بل ثورة في الفكر الإسلامي؛ لأنه جمع بين الشريعة والتصوف، وبين الظاهر والباطن، وبين الفقه العملي والتزكية الروحية. لذلك لُقّب الغزالي بــ”حجة الإسلام”.
لكن هذه العودة إلى اليقين لم تكن نهاية رحلته، بل كانت بداية مرحلة جديدة أعمق وأعظم؛ مرحلة البحث عن الحقيقة الكاملة من خلال التجربة الروحية والمعرفة الذوقية، بعد أن استنفد كل ما عند العقل من قدرة. ومن هنا بدأ الغزالي يتأمل في الفرق والمذاهب الموجودة في عصره، محاولًا أن يكتشف من أين تُنال الحقيقة الكاملة. فانحصرت هذه الفرق في أربعة أصناف رئيسية، وهذا ما سنتعرف علية في الجزء الثاني من المقال.
المراجع:
[1] تقع مدينة طوس ونيسابور في أقصى الشمال الشرقي لإيران، بالقُرب من حدودها مع أفغانستان وتركمانستان. وهما مسقط رأس وموطن كثير من أعلام الإسلام؛ ومنهم: أبو حامد الغزالي، وأبو علي بن سينا، وأبو مسلم الخُراساني، وأبو الريحان البيروني، وأبو نصر الفارابي، وأبو القاسم الفردوسي، ونصير الدين الطوسي، وآخرين.
[2] (سورة ق: الاية 22).
[3] (سورة الانعام: الاية 125).
وبكدة نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول من المقال عن رحلة الغزالي من الشك إلى اليقين، وكتابة إحياء علوم الدين للامام: ابو حامد الغزالي.
تابعونا في المقال القادم نستكمل في الجزء الثاني الحديث عن دراسة الفرق الأربع : للامام: ابو حامد الغزالي.
للحصول على مزيد من المعلومات برجاء متابعى على المنصات التالية:
الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088893776257
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@ashrafrashad8031
التيك توك:https://www.tiktok.com/@ashraf.r1
الانستاجرام: https://www.instagram.com/ashraf.rashad.58